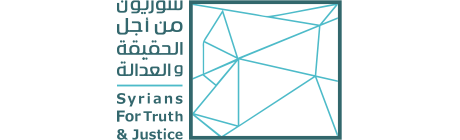مقدمة: النزاع في سوريا حالياً على مفترق طرق. لقد أمّنت القوات النظامية السّورية وحلفاؤها المناطق المحيطة بالعاصمة دمشق ومحافظتي حمص وحماه تاركةً المناطق البعيدة عن سيطرتها في الشمال الغربي (إدلب وجزء من ريف حلب وحماه) والجنوب الغربي من سوريا (أجزاء من درعا والقنيطرة) تحت سيطرة قوات معارضة مسلّحة وأخرى جهادية، بالإضافة إلى تركها للمناطق الشمالية الغربية (مناطق درع الفرات وعفرين) تحت سيطرة الأتراك. كما وتركت مناطق شرق نهر الفرات تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي.
وفي الوقت الذي يتم فيه رسم هذه الخطوط، انخرطت القوات السّورية وحلفاؤها مؤخراً في معركة بالجنوب السوري في منطقة “خفض التصعيد” وذلك في انتهاك للاتفاقية الثلاثية المبرمة بين روسيا والأردن والولايات المتحدة[1]. العمليات العسكرية التي بدأت في 17 تموز قد تسببت حتى الآن في نزوح ما لا يقل عن 325000 شخص. وقد تؤثر هذه العمليات على أمن المنطقة مع وجود إسرائيل والأردن على الحدود، ومع إيران المتمركزة في سوريا.
جهود السلام غير مرضية إلى حدٍ كبير، وتجري حالياً مجموعتان من محادثات السلام؛ المجموعة الأولى يتم إجراؤها من قبل الأمم المتحدة في جنيف التي بدأتها في عام 2012 والتي لم تنجز أي تقدمٍ ملحوظ خلال السنوات الست الماضية. وبالتزامن مع تلك الجهود فقد لعبت روسيا وإيران وتركيا دور الضامن لمجموعة أخرى من محادثات السلام والتي سُميت بمحادثات الأستانة. على أية حال، فإن هذه المحادثات لا تعير اهتماماً يذكر للمدنيين الذين هم حتى الآن أول ضحايا النزاع، واتفقت بدلاً من ذلك على عملياتٍ وضع نقاط مراقبة عسكرية ومناطق “خفض تصعيد” بهدف تأمين تأثيرها على النزاع، في الوقت الذي تحد فيه من تكلفة تورطها.[2]
بالإضافة إلى ذلك، خلال الأيام القليلة الماضية، أبرمت عدّة بلدات في درعا اتفاقاتٍ مع النظام السوري تنصّ أساساً على نزع السلاح من بعض فصائل المعارضة السّورية المسلّحة، وعدم التفكير في الانتهاكات السابقة أو قضايا حقوق الانسان. وعلى العكس، فإن نقل النزاع إلى الجنوب السوري ينبغي أن يدفع جميع أصحاب المصلحة إلى تشجيع الأطراف المتحاربة من أجل فتح حوار وفق المرجعيات الدولية.
“ينبغي على أيّة محادثات سلام وضع قضايا حقوق الإنسان في جوهر الاتفاقيات، ليس فقط لأسبابٍ أخلاقية ومعنوية بل أيضاً لأنها الطريقة الوحيدة لضمان سلامٍ دائمٍ في سوريا. ينبغي معالجة الكمّ الواسع من القضايا.”
في القضية الأولى من هذه السلسلة المكرسة للحديث عن اتفاقيات السلام، أخذنا بعين الاعتبار المكانة التي يجب إعطاؤها للسجناء في اتفاقيات السلام. وهنا (في هذه الورقة الثانية والأخيرة) سوف نقوم بدراسة قضية الاختفاء القسري وكيفية وجوب التعامل معها خلال محادثات السلام، وأخيراً في اتفاقيات السلام.
يُعرّف الاختفاء القسري على أنه عملية إخفاء الشخص خلافاً لإرادته، ويشمل ذلك حالات الخطف العشوائي واعتقال المدنيين خلال فترة الصراع أو الدكتاتورية. بعد عملية الخطف، يتم تجريد المختفي من الحماية القانونية ويُمنع عن أهله وذويه معرفة أيّة معلوماتٍ عن مصيره. قد يحدث الاختفاء القسري في المراحل الأولى من الاعتقال أو بعد ذلك.[3]
أولى ضحايا الاختفاء القسري هم المختفون/ات أنفسهم، فعند اختطافهم، يتم اعتقالهم وتعذيبهم وفي بعض الأحيان يتم قتلهم.[4] بالإضافة إلى ذلك فإن عبء الاختفاء القسري يكون ثقيلاً على ذوي وأقارب الضحايا المباشرين بطرق لا تُحصى.
المادة 24 من الإتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري -بهذا الخصوص- تعتبر أن الضحايا ليسوا فقط أولئك المختفون، بل إن أي شخصٍ يعاني من الاختفاء هو أيضاً ضحية بمن فيهم العائلة التي تتأثر من نواحٍ عدة.[5]
في أب/أغسطس 2017 ، نشرت منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة بالشراكة مع منظمة العدالة من أجل الحياة نتائج أبحاثهم بشأن أثر حالات الاختفاء القسري على الأسر.[6]
أولاً، عدم التأكد من مصير المختفي يجعل الأهالي يتأثرون بشكلٍ عميق كما ويؤثرعلى صحتهم العقلية والجسدية. ثانياً، المختفي يترك العائلة تعاني من مصاعب مالية.
ثالثاً، إن الخوف الذي يشعر به أقارب المختفي وجيرانه من ارتباطهم بعائلة المختفي يؤدي إلى بقاء العائلة منبوذة اجتماعياً.
وأخيراً، فإن عدم معرفة مصير المختفي وفيما إذا كان متوفياً أم لا، يجعل العائلة غير قادرة على إنجاز الإجراءات الإدارية، كما تجعلها عرضة للمصاعب القانونية والإدارية وتمنعها من الاستمرار في نيل حقوقها الأساسية والتزاماتها مثل تسجيل مولودٍ جديد أو تحصيل الميراث أو الطلاق.
في سوريا، اتسم النزاع كثيراً بوقوع جرائم الاختفاء القسري على نطاقٍ واسع والتي ارتكبتها كافة أطراف النزاع. تم توثيق ذلك من قبل جهات عديدة منها سوريون من أجل الحقيقة والعدالة وهيومن رايتس ووتش في 2012 ووثقتها لجنة التحقيق الدولية حول سوريا في عام 2013 ، ولم تنخفض من ذلك الحين، وحتى آب/أغسطس 2017 كان قد تم إحصاء (85,036) ضحية من ضحايا الاختفاء القسري.[7] في شباط/فبراير 2017، وضع مجلس الأمن للأمم المتحدة مسودة القرار 2139 الذي يدين فيه حدوث الجرائم، ولكن دون حدوث أي تأثير فعلي.[8]
من الصعب التوقع بمسار النزاع، ولكن بإمكاننا فقط الاعتماد على معارفنا بهذا المجال وأن نتعلم من تجارب النزاعات السابقة في دول أخرى. وعلى الرغم من أن القوات النظامية السّورية – كما ذكرنا آنفاً- باتت تستولي على جزء كبير معظم الأراضي السوريّة -محولة بذلك وجهة النزاع إلى مستواه المنخفض- فإن اتفاقية السلام لا تزال أساسية في المستقبل القريب أو البعيد.
لقد وضعنا تصوراً ورؤية للمواضيع الأساسية المرتبطة بالاختفاء القسري والتي ينبغي مراعاتها كجزءٍ من أي مفاوضات سلام من قبل الوسطاء والأطراف المتحاربة وأصحاب المصالح والناشطين في مجال حقوق الإنسان. فلإنجاح مفاوضات سلامٍ موفقة ذات مغزى، سوف نبدأ بوضع شروطٍ أساسية:
(1) مشاركة المرأة في المحادثات والتي بدونها يكون الأمل في السلام مقدراً له بالفشل.
(2) بعد ذلك سوف نركز على قضية إصلاح القوانين فيما يخص الاختفاء القسري، أولاً كمحاولةٍ للالتزام بالقانون الدولي وثانياً لتحسين القانون المحلي.
(3) سوف ندرس القضايا المتعلقة بالاختفاء القسري التي نعتقد أنه من المهم التطرق لها خلال محادثات السلام.
(4) سوف ننتهي بنظرة شاملة لتنفيذ عمليات السلام، مع الإشارة إلى الأدوات التي ، إذا ما تم التخطيط لها بشكل جيد في مفاوضات السلام والمنصوص عليها بالاتفاقية، يمكن أن تساعد في ضمان الإمتثال لأحكام حقوق الإنسان.
أولاً: مشاركة المرأة في مفاوضات السلام: شرطٌ أساسي من أجل سلام مستدام:
لقد اختبر الرجال والنساء على حدٍ سواء الاختفاء القسري بطرقٍ عدة. فإذا كان معظم الضحايا المباشرين للاختفاء القسري هم من الرجال، فإن النساء تمثلن نسبياً بالتبعية الضحايا الثانويين، إذ أنه يتم تركهن ويتعين عليهن الاعتناء بالعائلة في غياب الرجل الذي كان هو -على الأغلب- معيل الأسرة. يؤدي هذا إلى تأثيراتٍ غير متجانسة عليهنَ من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والنفسية.
فمن الناحية الاجتماعية، “وصمة العار” التي تحيط باختفاء الزوج أو الأب أو الأخ تميل إلى أن تبعدهن عن المجتمع الذي يخاف من أن يتم ربطه بالأعداء ومواجهة نفس المصير[9]. النساء اللواتي يختفي أزواجهن أيضاً يُتركهن في حالة فراغٍ زوجي وتصبحن غير قادرات على الطلاق أو الزواج مرةً ثانية.[10] أما من الناحية الاقتصادية، فتجبر النساء على القيام بأعمالٍ قليلة الأجر أو أعمالٍ غير آمنة.[11] ويمكن ملاحظة هذه النتائج بسهولة في سوريا حيث أن 90 % من الضحايا المباشرين للاختفاء القسري هم من الرجال والذين يشكلون المعيل الأساسي للعائلة[12] في مجتمعٍ ذكوري كالمجتمع السوري.
وبالنتيجة، انخرطت قلةٌ من النساء في عمليات السلام المستمرة حيث ثبت أنهن عاملٌ قويٌ للسلام. القرار 1325(قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة) يرسي جدول الأعمال الخاص بالمرأة والسلام والأمن على المستوى الدولي، كما ويعترف بمساهمة المرأة في حل النزاع ومنعه. إحدى الركائز الأربعة لقرار مجلس الأمن تُركز بشكلٍ مباشر على مشاركة المرأة في مفاوضات السلام[13]. تُؤكدّ تجارب الدول في كلّ من: الفليبين وإيرلندا الشمالية وغواتيمالا وكينيا والسودان ودارفور وكولومبيا وميانمار وأوكرانيا، أنّ مشاركة المرأة كانت فعالة في إنجاح عملية السلام والسلام الدائم.[14]
هناك مثالان جديران بدراستهما:
في غواتيمالا، على الرغم من قلة أعداد النساء اللاتي جلسن نيابة عن الأطراف في المفاوضات، إلا أن ناشطات السلام النساء انتظمن رسمياً وانضممن إلى “جمعية المجتمع المدني” التي سمحت لهن بالمشاركة في محادثات السلام وتقديم قضايا تتعلق بالمرأة. لقد قمنَ، خلال عملية السلام ككل، بتقديم مسودة مقترحاتٍ غير ملزمة للأطراف المتفاوضة، وأبلغنَهم بالقضايا الأساسية وأثّرن عليهم. وأخيراً استطعنَ إدخال سلسلةٍ من القضايا من منظورٍ موجه للمرأة في عملية السلام، مثل قضايا “الحصول على أراضي، المساعدة في التطوير والائتمان، الحد من التمييز ضد نساء الشعوب الأصلية، دعم حقوق المرأة والمساواة ضمن البيت، حقوق عمل متساوية للنساء العاملات، الحصول على فرص تعليمٍ أكثر للنساء، وزيادة فرص النساء من أجل الخدمة في القوات المسلحة.”[15]
في كولومبيا، كانت المرأة حاضرةً في عملية السلام على كل المستويات بما فيها بوصفها مسؤولةً في مكتب المفوضية العليا للسلام التابع للحكومة.[16] كما أن انخراط المرأة المتزايد في عملية السلام أنتج تأثيراتٍ إيجابية على مجموعةٍ من المواضيع. فبالإضافة إلى تركيزها على حقوق المرأة والفتيات، يُعزى لها الالتزام بتقديم قضايا جوهرية إلى عملية السلام فيما يخصّ الضحايا مثل ردّ الأراضي والحق في العدالة والمساءلة. كما أنها لعبت دوراً مهماً في تحسين حالة الأمن من خلال التفاوض على وقف إطلاق نارٍ محلي، وتسهيل إطلاق الرهائن، ومناصرة إجراءات استعادة رفاة المختفين.[17]
كيف ينطبق هذا على سوريا؟
في مجتمعٍ ذكوري على نحو مبالغ فيه، يتم تمثيل المرأة السورية تمثيلاً غير كافٍ في المناقشات الرفيعة المستوى. لذا فمن الضروري خلق مساحةٍ لهنّ واشراكهن في مفاوضات السلام بشكل فعّال من قبل صانعي/ات السلام والوسطاء. و أن تكون الحركات النسائية جزءاً رسمياً من المفاوضات. ودعم وتطوير المبادرات مثل “المجلس الاستشاري النسوي” في محادثات السلام التابع للأمم المتحدة والحركات السياسية النسوية الأخرى في جميع الأراضي السورية بدون استثناء. كما ويجب على المتفاوضين زيادة عدد التمثيل النسائي ضمن وفودهم. وهذا يعني، من بينها:
- شملهنَ في المراكز القيادية.
- تقدير خبراتهن.
- رفع مستوى حمايتهن وأمنهن.
- الإصرار على الاعتبارات الجنسانية.
- تخصيص التمويل المكرّس لدعم مشاركة المرأة.
- مراقبة وتقييم تنفيذ هذه الأهداف.[18]
ثانيا: ضرورة العمل على الصكوك القانونية:
الاحترام الثابت لسيادة القانون هو أساس سلامٍ دائمٍ مستدامٍ. يجب تحقيقه بالاشتراك مع إصلاح القانون الذي يضمن احترام القانون السوري للمعايير الدولية. على محادثات السلام معالجة الفجوة التي تميّز القانون السوري بشأن حالات الاختفاء القسري فيما يخص القانون الدولي والقانون المحلي.
- الالتزام بالقانون الدولي:
تشكل عدّة أحكام النظام القانوني لمحاربة حالات الاختفاء القسري في القانون الدولي لحقوق الانسان، والقانون الدولي الإنساني، والقانون الجنائي الدولي.
- القانون الدولي لحقوق الانسان:
يُعدّ القيام بفعل الاختفاء القسري انتهاكاً مستقلاً لحقوق الانسان وتدينه عدة صكوك:
- إعلان الأمم المتحدة بشأن حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري المؤرخ في 1992 .[19]
- اتفاقية البلدان الأمريكية للعام 1994 بشأن الاختفاء القسري للأشخاص.[20]
- الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري للعام 2007 والتي تضع ثلاث عناصر جوهرية لحالات الاختفاء القسري:
- هناك الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية.
- الذي يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعاتٍ من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة.
- ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده مما يحرمه من حماية القانون.
من جهةٍ أخرى، فإن جريمة الاختفاء القسري هي أيضاً انتهاكٌ لحقوق الانسان المتعددة المنصوص عليها في الصكوك الدولية والتي صادقت عليها سوريا، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تنصّ على:
- لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه.
- الحق في عدم اخضاع الشخص للتعذيب ولا المعاملة أو العقوبة القاسية اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.
- الحق في الأمن والكرامة الشخصية.
- الحق في ظروف اعتقالٍ إنسانية.
- الحق في التمثيل القانوني.
- الحق في المحاكمة العادلة.
- الحق في الحياة الأسرية.
- والحق في الحياة في حال تم قتل الشخص المختفي.
بالإضافة إلى ما سبق، يتم ربط حالات الاختفاء القسري بشدّة بالحق في معرفة الحقيقة. في الواقع كان هذا الحق في بادئ الأمر وسيلةً من قبل “أمهات ميدان مايو” عندما نشرت أمهات الأرجنتينيين في العام 1977 بياناً للمطالبة فيه بمعرفة الحقيقة حول مصير أولادهن المختفين من قبل المجلس العسكري وكانت آنذاك وسيلةٍ غير سياسية ليس فقط لتجريد عنف الدولة سياسياً، بل أيضاً كصكٍ قانوني لإصلاح غياب الحماية القانونية التي عانى منها المفقودون. أما الآن فالحق في معرفة الحقيقة هو حقٌ مستقلٌ بذاته تؤكده الأمم المتحدة وهو منصوصٌ عليه في البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، التي صادقت عليها سوريا، وينص في المادة 32 إلى المادة 34 على “حق كل أسرةٍ في معرفة مصير أفرادها.”[21]
لقد ساهمت هيئات حقوق الانسان الإقليمية والعالمية بشكلٍ كبيرٍ في تطبيق تجريم الاختفاء القسري وبناء قانون السوابق القضائية فيما يتعلق بحالات الاختفاء القسري. من بين أكثر القضايا السيئة السمعةً هي قضية بازوركينا ضد روسيا حيث أقرت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان بحق الأُسّر والأقارب قي مطالبة السلطات بأنهم بمثابة الضحايا بناءً على رد فعل السلطات و موقفها عندما يتم إعلامها بحالة الاختفاء.
أما في قضية “فيلاسكيز ردوريغز” ضد هندوراس، فقد أقرت محكمة البلدان الأمريكية بأن جريمة الاختفاء القسري هي “انتهاكٌ متعددٌ ومستمرٌ لعددٍ من الحقوق المنصوص عليها بحسب الاتفاقية التي تُلزم الدول الأطراف باحترامها وضمانها”. وفي قضية “إدريس الحسّي” ضد جمهورية ليبيا، ذكّرت لجنة حقوق الانسان للأمم المتحدة الدول الأطراف بواجباتها في معالجة الانتهاكات المزعومة للحقوق بموجب قوانينها المحلية.[22]
كيف ينطبق هذا على سوريا؟
سوريا حالياً ليست طرفاً في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. على نحوٍ مماثل، بالرغم من أنها طرفٌ في الاتفاقية لمناهضة التعذيب، إلا أنها أعلنت أنها لا تعترف باللجنة التي لا تتعاون معها وبذلك تُجبر اللجنة على بحث حالة سوريا في حالة غياب التقرير.[23]
” على صانعي/ات السلام وضع قضية الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري على طاولة الحوار والدفع نحو المصادقة عليها من قبل سوريا ودمجها في القانون المحلي.”
من جهةٍ أخرى، في العام 2004 مجلس جامعة الدول العربية والتي سوريا طرفٌ فيها، تبنى الميثاق العربي لحقوق الانسان الذي صادقت عليه سوريا، وينص الميثاق على الحقوق الأساسية مثل الحظر من التعذيب، المساواة أمام القانون، والحق في الحرية والأمان. لم يكن لدى الميثاق أي هيئةٍ تنفيذيةٍ لمدة عشر سنوات وبقي عملياً وهمياً. لكن في العام2014 ، أنشأت جامعة الدول العربية نظاماً تشريعياً لمحكمةٍ عربية لحقوق الانسان ولكنها أثبتتت عدم الرضا، فالقضية الأولى تكمن في عدم قدرة المواطنين على رفع شكوى في المحكمة مما دفع بالبروفسور “شريف بسيوني” إلى أن ينعت المحكمة بأنها “محكمةٌ زائفة” في إشارةٍ منه إلى طبيعتها الخادعة[24].
صانعو/ات السلام والناشطون/ات في مجال حقوق الانسان يمكنهم الاستفادة من الظروف في عملية صنع السلام في سوريا لدفع جميع الأطراف للمباشرة في التفكير بفرصة إصلاح مثل هذه الهيئة.
النزاع الحالي الذي تشارك فيه تقريباً جميع الجهات الفاعلة في المنطقة وحتى مع نقل النزاع إلى الجنوب السوري يخلق زخماً لفكرة إصلاح المحكمة العربية والدفاع عن تحقيقها. يبدو أن هذا التحدي لا يقهر لكن يستطيع النشطاء التمعن في العمل الذي أنجزه نظراؤهم الأفارقة والذين أخذوا منظمة الوحدة الأفريقية التي كانت تتعامل فقط مع المسائل الاقتصادية وانهاء الاستعمار إلى مستوىٍ جديد من خلال الدفع لصياغة مسودة الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والذي دخل حيز التنفيذ عام .1986 وتم تأسيس اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بعد فترةٍ وجيزة -أي في تشرين الثاني عام 1987 في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا- ، ولكنها استغرقت عشر سنواتٍ لتشهد تأسيس هيئةٍ تنفيذيةٍ مع البروتوكول الملحق بالميثاق الافريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن إنشاء محكمةٍ أفريقية في عام 1998والتي بدأت أعمالها بعد ست سنواتٍ أخرى من تأسيسها مع المصادقة عليها من قبل الدولة الخامسة عشر في العام 2004 . في لحظاتٍ مترددة، يمكن للنشطاء أن يأخذوا بعين الاعتبار أنّ الدول الافريقية الأعضاء في اللجنة لم يسهّلوا العملية: “إذ كان القادة دكتاتوريين عسكريين غير منتخبين وغير ديمقراطيين والبعض الآخر كان من دولة الحزب الواحد ورؤساء مدى الحياة، وهو نظام حكمٍ رائجٍ في القارة.”[25] نفس العوائق كانت أمام إنشاء محكمة البلدان الأمريكية إذ أن الدول الأطراف الأربع والعشرون في الاتفاقية الامريكية لحقوق الانسان يمتلكون سجلاً واسعاً من الانتهاكات والممارسات المدعومة من قبل الدولة كالتعذيب والاختفاء القسري و القتل العشوائي.
- القانون الإنساني الدولي:
حظر الاختفاء القسري قاعدة في القانون الدولي العرفي الذي ينطبق على كل من النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. وعلى الرغم من أنه لم يتم الإشارة إلى جريمة الاختفاء القسري بحدّ ذاتها، إلا أنّ ارتكابها ينتهك مجموعةً من القواعد بما فيها حظر الحرمان التعسفي من الحرية (القاعدة 99)، وحظر التعذيب وأي معاملةً قاسيةً أو الحاطة بالكرامة (القاعدة 90)، وحظر القتل (القاعدة 89). ولأن الاختفاء القسري متأصلٌ في عقول الجيوش حول العالم، فإحدى الوسائل لمحوه هي اصلاح المؤسسة وتعليم المجندين على حظره كما هو الحال في كولومبيا والسلفادور واندونيسيا وبيرو.
كيف ينطبق هذا على سوريا؟
على صانعي السلام والناشطين في مجال حقوق الانسان دفع الأطراف لإدراج اصلاح المؤسسات في اتفاقية السلام منذ بداية المناقشات، وأن تتضمن، كما هو الحال في البلدان الآنفة الذكر، حظر الاختفاء القسري في الكراسات العسكرية.
- القانون الجنائي الدولي:
المحكمة الجنائية الدولية في نظام روما الأساسي لعام 1998 صنفت في المادة 7 جريمة الاختفاء القسري بأنها جريمةٌ ضد الإنسانية متى ارتُكبت في إطار هجومٍ واسع النطاق أو منهجيٍ موجه ضد أي مجموعةٍ من السكان المدنيين.[26] وهي تعطي تعريفاً مشابهاً لتعريف الاختفاء القسري في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، على الرغم من أن نظام روما الأساسي يوسّع نطاق مرتكبي الاختفاء القسري ليشمل الجماعات السياسية، فإنّ الاتفاقية أشارت فقط إلى الدولة ومسؤولين فيها.
وبحسب المادة 7، فإن ارتكاب جريمة الاختفاء القسري ينبغي أن يكون “جزءاً من هجومٍ واسع النطاق أو منهجيٍ موجه ضدّ أي من السكان المدنيين، وعن علمٍ بالهجوم.” وهو هجومٌ تم تعريفه في الفقرة 2 من نفس المادة “كنهج سلوكي يتضمن الارتكاب المتكرر للأفعال المشار اليها في الفقرة 1 ضدّ أي مجموعةٍ من السكان المدنيين، عملاً بسياسة دولةٍ أو منظمةٍ تقضي بارتكاب هذا الهجوم، أو تعزيزاً لهذه السياسة.” المحكمة الجنائية الدولية لم تنظر بعد في حالة من حالات الاختفاء القسري.
كيف ينطبق هذا على سوريا؟
سوريا حالياً ليست من الموقعين على نظام روما الأساسي. و يكون للمحكمة الجنائية الدولية ولايةٌ قضائية على سوريا فقط إذا ما أحال مجلس الأمن القضية على محكمة الجنايات الدولية، أو في حال صادقت سوريا على نظام روما الأساسي. ولأن هذا يبدو بعيدًا وغير مؤكداً، فإنّ من مسؤولية الناشطين في مجال حقوق الانسان والمحامين والمنشقين السياسيين الدفع باتجاه تصديق سوريا على نظام روما الأساسي وأن تكون جزءاً لا يتجزأ من محادثات السلام.
- إصلاح القانون المحلي:
التصديق على الصكوك الدولية يتضمن دمجها في القانون المحلي. لذا يستكشف هذا الجزء التغييرات على المستوى المحلي.
في البوسنة والهرسك، كان من 25 ألف – 30 ألف شخصٍ مفقوداً بعد حدوث النزاع. بسبب غياب الأحكام في اتفاقية دايتون عام 1995 لصياغة قانون بشأن الأشخاص المفقودين، فقد استغرق عشر سنواتٍ تقريباً لتبني القانون 2004 الذي أسّس لجنة الأشخاص المفقودين المعني بتبني اللجان الإقليمية الموجودة في المنطقة وحدد وضع وحقوق عائلة الشخص المختفي وألزم السلطات أن تعطي تقريراً عن كل الأشخاص المفقودين من خلال تقديم المعلومات و الدعم للجنة الأشخاص المفقودين. بالإضافة إلى أنه أنشأ قاعدة بياناتٍ مركزية للمفقودين وأسس صندوقاً لتمويل عائلات المختفين.
في النيبال، تم توقيع اتفاق السلام الشامل في العام 2006 لوضع حدٍ لعقدٍ من الصراع العنيف بين الحكومة النيبالية والحزب الشيوعي النيبالي (الماوي) الذي راح ضحيته أكثر من 14 ألف قتيل وسبب اختفاء ألف وأربعمائة شخص. عملية السلام لم تخطط من أجل اصلاح القانون المحلي أو تجريم الاختفاء القسري. على الرغم من أنّ هناك قضيتين في المحكمة العليا وهما قضية راجيندرا براسال دهكال ضد حكومة نيبال (العام 2007) وقضية مادهاف كومار باسنيت ضد حكومة نيبال (العام 2014)_ و بالرغم من أنّ لجنة التحقيق بشأن الأشخاص المختفين قسراً قد حشدت الرأي العام لتجريم عدة جنحٍ بما فيها الاختفاء القسري، إلا أنّ صناع القانون لم يُفلحوا في اصلاح القانون النيبالي في ذلك الاتجاه[27].
كيف ينطبق هذا على سوريا؟
توضح كل هذه الأمثلة العمليات المطولة التي تنشأ كنتيجةٍ عن عدم الالتزام المحدد بإصلاح القانون في اتفاقيات السلام. يجب على الأطراف وصانعي السلام والناشطين في مجال حقوق الانسان الالتزام بوضع قضية اصلاح القانون في صميم هذه المناقشات والتخطيط لقانون يجرّم الاختفاء القسري. ستكون القضية حاسمةً في تأكيد تكريس الحكومة اللاحقة لضمان الالتزام بسيادة القانون.
ثالثا: جوهر المفاوضات:
التفكير الشامل بجريمة الاختفاء القسري وتأثيرها على الأفراد والعائلات والنسيج الاجتماعي أمرٌ حاسمٌ لاتفاقية السلام الرّامية إلى سلامٍ دائمٍ. يناقش هذا الجزء مواضيع حساسة يجب على اتفاقية السلام معالجتها. وتشمل (أ) قضية العفو المرتبطة بسياق محادثات السلام إذ أنها على الأغلب تشكل جوهر مخاوف الأطراف المتحاربة. (ب) سوف نغوص في أسئلةٍ محددة أكثر بشأن حالات الاختفاء القسري مثل إعطاء الفرصة لإنشاء هيئاتٍ مخصصة لقضية الاختفاء القسري. (ج) مسألة تعويض عائلات المختفين. (د) البحث عن المختفين. (ه )سوف ننتهي بنظرةٍ شاملة، سريعاً للاهتمام الذي تستحقه ولأهمية انشاء لجنةٍ للحقيقة في اتفاقية السلام.
أ. العفو:
لقد درسنا في الموضوع السابق الأهمية القصوى للعدالة. لا يمكن أن يشمل العفو أبداً مرتكبي جرائم الاختفاء القسري. ولقد شرحنا بأنّ العفو ليس فقط غير قانوني فيما يتعلق بالقانون الدولي بل إنّه أيضاً لا يخدم سلاماً مستداماً. من جهةٍ أخرى، فقد أثبتت المُساءلة أنها تدعم السلام القائم منذ أمدٍ طويل وتقلل من تكرار حدوث النزاعات.[28]
وقد يتم إجراء المشاورات في المجتمع السوري لجمع أصواتٍ لصدور العفو من أجل الجناة الذين ارتكبوا جرائم من مستوىٍ أدنى، إلا أنّ جرائم الاختفاء القسري الجسيمة لا يمكن أن تمرّ دون عقاب، ويجب التأكيد على هذا الموقف في المراحل الأولى من عملية السلام من مخاطر رؤية السياسيين وهم يُدرجون المسألة لاحقاً إلى طاولة الحوار.
في النيبال، كانت مسألة العفو غائبةً عن اتفاق السلام الشامل لعام 2007 وأدى هذا إلى محاولة السياسيين إدراجها لاحقاً في التشريع من أجل إنشاء لجنة الحقيقة والمصالحة في مناسباتٍ عدة بين 2007 و2014 بالرغم من نقض القضية من قبل المحكمة العليا.[29]
صانعوا السلام والأطراف عليهم أن يدركوا أنّ مسألة العفو مسألةٌ حساسةٌ للغاية بالنسبة للمجتمع وتُعيق عملية السلام وشرعية الأطراف. في كولومبيا، قيل أنّ سبب رفض اتفاق السلام في تشرين الأول/أكتوبر لعام 2016 المتفق عليه من قبل الحكومة والقوات المسلحة الثورية الكولومبية هو عدم رغبة الكولومبيين لما يرون أنه عفوٌ كريم.[30]
كيف ينطبق هذا على سوريا؟
ينبغي على مباحثات السلام معالجة موضوع العفو لتجنب الفراغ القانوني حوله الذي يمكن أن يُستخدم على حساب توطيد سيادة القانون في سوريا. لقد عالجنا في الصفحة الأولى من هذه السلسلة الجانب المهم من تجنب العفو لمرتكبي الجرائم الأكثر خطورة والتي تندرج ضمنها جرائم الاختفاء القسري. سوف يقوم الوسطاء بالتفكير ملياً في المناقشات بشأن العفو من خلال تقديم رؤى لتنوير النقاش، وسوف يُذكّروا الأطراف بأنّ العفو سوف لن يحمي الجناة من الملاحقة القضائية الدولية أو الأجنبية (على أساس الملاحقة القضائية العالمية). بالإضافة إلى أنّ الوسطاء بإمكانهم إبلاغ الأطراف أنّ العفو هو جزءٌ من اتفاقيات السلام وعلى الأرجح سوف يتم الطعن فيه في المحاكم الوطنية في المستقبل وأخيراً سوف يُلغى. في نهاية المطاف، الوسطاء سوف يحيطون المانحين الدوليين وهيئات الأمم المتحدة علماً بذلك وعلى الأرجح سوف تمنع تمويلها في حال نصّت اتفاقية السلام على العفو.[31]
ب. إنشاء هيئات متخصصة:
قضية الاختفاء القسري قضيةٌ مفجعة بالنسبة للضحايا وللمجتمع على حدٍ سواء. ونظراً لآثارها وتعقيداتها يُنصح أحياناً بإنشاء هيئاتٍ-في مرحلة ما بعد الصراع- للتعامل مع هذه المسالة بشكلٍ حصري.
في البوسنة والهرسك، قانون الأشخاص المفقودين لعام 2004 أنشأ لجنة الأشخاص المفقودين بعد حوالي عشر سنوات من اتفاقية دايتون. عملية إيجاد المختفين خلال فترة العشر سنوات كانت مقسمةً بين الجماعات الإثنية مما يعكس التوافقية التي تمّ التوصل إليها في الاتفاقية. بدايةً، جميع السكان المكوًنين من البوسنيين (البوشناق) والصرب البوسنيين والكروات البوسنيين، شكلت كل فئةٍ منهم لجنةً خاصةً بهم بشأن الأشخاص المفقودين وكانت كل لجنة تتعامل حصرياً مع الأفراد المختفين من جماعتها الإثنية. لجنتي البوسنيين والبوسنيين الكروات اندمجتا في وقت مبكر مع اللجنة الفدرالية المعنية بالأشخاص المفقودين ولكن بقي